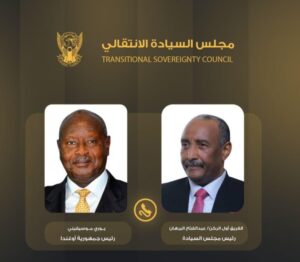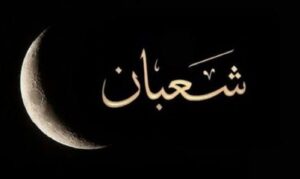الخرطوم=^المندرة نيوز^
يا صاحبي، أراك تسألني عن الحُمّى، وتُهذي كما كان يهذي أهل مكة فى المدينة يوم نزلوا بها، ويُدندن بلال بن رباح وهو يقول في شكواه من الحُمّى وحنينه إلى مكة:
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلةً ***
بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليلُ
وهل أردنّ يومًا مياهَ مجنّةٍ ***
وهل يبدون لي شامةٌ وطفيلُ
فكان في أنينه صدى الحنين، وفي شكواه من الحُمّى أنينُ الجسد المشتعل بحرارتها، وحنينُ الروح المشتاق إلى وطنها.
ثم تمضي، فتسألني عن الحُمّى في لغة العرب، وعن صورها في أشعارهم، وكيف جعلوها زائرةً وعشيقة، وخصمًا وعنيدة، ورمزًا للبلاء والرجاء، والوجع والشفاء.
يا صاحبي عافك الله .. عرف العربُ الحُمّى كما عرفتها الأممُ القديمة؛ فهي عندهم نارٌ تتأجج في العروق، وثلجٌ يذيب قوى الأجساد، تلتقي فيها الأضداد: حرارةٌ محرقة وبرودةٌ منهكة، يقظةٌ للجسد وسُباتٌ للروح. كانت الحُمّى امتحانًا بين الضعف والقوة، وصراعًا بين العافية والسقم، وأنينًا يعلو من الجسد يجاوره صبرٌ ينبع من الروح. ولذا ما اكتفوا بعلاجها بالماء الزلال والملطفات، ولا بالدواء والعشب فحسب، بل زادوا على ذلك بالذكر والدعاء، فكانت معركتهم معها معركة جسدٍ وروحٍ معًا.
وقد خلّد أطباؤهم أوصاف الحُمّى في أقلامٍ بارعة، ورسائل ضافية، ومقالاتٍ وافية، فارتفع الطبّ بهم إلى حيث يلامس الأدب. ومن أعظم ما أُلف في هذا الباب كتاب الحُمّيّات لإسحاق بن سليمان الإسرائيلي، في خمس مقالات لم يأت الزمان بأجود منها؛ جمعت بين حكمة النظر، ودقة التجربة، وغزارة المعرفة، حتى غدت مرجعًا يُشار إليه بالبنان، وعلاجًا أثبتت الأيام نفعه بالبرهان.
وكان إسحاق، ذلك الطبيب الذي عاش قرنًا وزاد، مثالًا للعزلة المضيئة؛ لم يتزوج ولم يعقب، فعيّره الناس، فرد عليهم بكلمة خلدها الدهر: “إن لي أربعة كتبٍ تُحيي ذكري أكثر من الولد: كتاب الحُمّيّات، وكتاب الأغذية والأدوية، وكتاب البول، وكتاب الأسطقسات”. فجعل من مؤلفاته أولادًا فكريةً باقية، تَشيخ الأعمار وتظلّ هي نضرةً كالينبوع، يزول الجسد ويبقى الذكر. ولئن رحل عن الدنيا سنة ٣٢هـ (٩٣٢م)، فإن كتبه لم تزل حيّة في رفوف الأطباء وعقول القرّاء.
ولم يكن وحده في هذا الميدان؛ فقد نسج محمد بن إبراهيم رسالته في الحمى، وألّف جلال الدين السيوطي غيرها، وجاءت الرسائل تترى، كالسيل المنحدر، تحصي أنواع الحمى وأعراضها، وتستقصي أسبابها ومعالجاتها. حتى بدا للقارئ أن الحمى لم تكن مرضًا عابرًا، بل كانت مدرسةً للعلم، وميدانًا للأدب، ومختبرًا لجلَد الروح.
وهكذا ياعافاك الله التقت في موضوع الحمى الأضداد والمتناقضات:
بلاءٌ وشفاء، نقمةٌ ونِعمة، نارٌ تطهّر وريحٌ تعصف.
وكانت – فوق ذلك – صورةً تمثيليةً للحياة نفسها؛ كما تشتد الحمى ثم تخمد، كذلك الدنيا تصطخب ثم تهدأ.
ولم يقف وصف الحمى عند الأطباء؛ فقد اتخذها الشعراء مادّةً لألحان الوجع وأنغام الأنين. جعلوها تارةً زائرةً ليلية، وتارةً خصمًا عنيدًا، وأحيانًا محبوبةً ماكرة، تتزين بالعذاب وتترقرق بالدموع. فغدت قصيدةً من نار، وغناءً من وجع، وصورةً من بلاغة.
وها هو المتنبي – شاعر الكبرياء – لا يخضع إلا لحمّاه في مصر. رسمها أنثى تأتيه في الليل، محتشمة في قدومها، متدللة في إصرارها، زائرةً لا تغادر العظام:
وزائرتي كأن بها حياءً …
فليس تزور إلا في الظلام
بذلتُ لها المطارفَ والحشايا …
فعافتها وباتت في عظامي
فجعلها حبيبةً عنيدة لا تقبل فراش الحرير، بل تختار نخاع العظم مسكنًا. وحين تغادره عند الصبح، تبكي دموعًا كالسحاب. ومع ذلك ظل المتنبي متمسكًا بعزيمته، يقول:
فإن أمرض فما مرض اصطباري …
وإن أحم فما حم اعتزامي
أما ابن شيروية الديلمي، فقد رآها زائرةً ثقيلة، تأتي بلا استئذان، وتُفسد العيش، وتكدّر اللذات:
وزائرة تزور بلا رقيب …
وتنزل في الفتى من غير حبه
أتت لزيارتي من غير وعد …
وكم من زائرٍ لا مرحبًا به
وأبو بكر الخوارزمي صوّرها امرأة غاضبة تغار من الطعام والشراب، لا تحتمل منافسة:
كأن لها ضرائرَ من غذائي …
فيغضبها شرابي والطعام
وأميرٌ مبتلى كناصر الدين بن النقيب، خاطبها بلهجة الآمر، فأجابته بلسان القدر:
أقول لنوبة الحمى اتركيني …
فقالت: كيف يُترك من حُمي؟
فذابت الأوامر أمام سلطانها، فلا جاه ينفع ولا منصب يدفع.
وكان أبو الفتح كشاجم الرملي يراها نارًا أوقدها الفكر، وليست بردًا في العصب كما زعموا. وأبو نواس جعل منها غزلًا حين نسبها إلى جاريةٍ أحبها تُدعى عنانًا:
إني حُمِمتُ ولم أشعر بحماك …
حتى تحدّث عُوّادي بشكواك
وهكذا يا رعاك الله، لم تكن الحمى عند العرب عارضًا صحيًا فحسب، بل كانت ملحمةً من الصور والرموز: زائرةً، خصمًا، محبوبةً، عشيقةً، نقمةً ونِعمة. أخذت من الأطباء علمًا، ومن الشعراء خيالًا، فغدت نارًا وضياءً، بلغةٍ حفلت بالطباق والجناس، وزُخرفت بالمترادفات والتكرار، حتى صار وصفها معجمًا متشعّبًا تلتقي فيه البلاغة بالطب، والعلم بالشعر، والحقيقة بالخيال.
فهي عندهم نارٌ وبرد، حضورٌ وغياب، موتٌ وحياة. قصيدةٌ كونية تملي أبياتها على الجسد، وتترك في الروح أثرها. وإذا أصابتها يد القدر قيل: “حُمَّ الرجل”، وكأن البلدة نفسها تتآمر فتُحمّيه.
عدّوا لها منازل وأسماء: فهي( المردم) إن لزمت المريض أيامًا، و(النائبة) إن عاودته يومًا بعد يوم، و(البرحاء) إذا بلغت العظم، و(الرس) إذا باغتت في بدايتها، و(العرواء) إن قارنتها رعدة، و(الرحضاء) إذا فاض العرق بعدها، (الصالب) إن صحبها صداع، و(النفض) إذا رجفت الأعضاء. وهي (الوعك) إذا اشتعلت بلا برد، و(الربع) إذا عادت في اليوم الرابع، و(الغب) إن داومت يومًا وتركت آخر، و(القلع) إذا طال مقامها. فإذا خمدت قيل: “انطفأ فوارها”، وكأنها نار تركت رمادها..وقد تكون (قبسا) من جسدٍ آخر، أو (عقابيل) من بثور صغيرة تترك أثرها على الشفاه. وقد تجعل المريض مسبوتًا، أو (مليلة) متأججة. تدور في أوقات وتغيب، فيسمونها( الدائرة)، حتى إذا انقطعت قيل: “أفرق المحموم”.
ولم يكن العرب وحدهم في هذا الباب؛ فقد عرف اليونان التيفوس والتيفوئيد، ورآهما الأطباء صورةً للنوم الثقيل. وعرف اللاتين جذور “الإحماء” في لغتهم، ومنها استمدت اللغات الأوروبية كلماتها. وهكذا اجتمعت اللغات كلها على صورة واحدة: نارٌ تسري في الجسد، وبلاء يوقظ الروح.
وفي لسان السودانيين، لم تكن الحُمّى مجرد ارتفاع في الحرارة، بل لها وجوه وأسماء متعدّدة، تصف شدتها أو أثرها على الجسد. فإذا أصاب الإنسان ارتفاع في حرارته قالوا: (عندو سخانة)، وهي الاسم الأشهر للحُمّى. وإذا لازمت المريض أيامًا طويلة قالوا: الحمّى ماسكاهو أو ملازموه، في إشارة إلى إصرارها على البقاء. أمّا إذا كانت تأتي في مواعيد محددة ثم تفارق، فقد سموها (الوردة)، لأن الوجه يتورّد بالحُمرة عند اشتدادها، ولأنها تعاود كالمواعيد الثابتة.
وحين يشتد المرض حتى يفتك بالقوى ويكسر العظم قالوا: جاتو (البرحا) أو الحمّى القاطعة، فهي نار لا تبقي ولا تذر. وإذا تكررت النوبات بشكل منتظم حتى كأنها تدق الجسد دقًا، سمّوها (الدُقّاقة). وإن كانت تدور في مواقيت وتغيب ثم تعود شبهوها بالقمر في منازله، وقالوا: دي (حمّى ادورور)
ومن الألفاظ التي تحمل أثر الحُمّى على الجسد قولهم: (السخسخة)، وهي التعبير عن الإنهاك الشديد والتكسر بعد طول المرض، فيقال: أنا (سخسخت) أي هدّني التعب وأرهقني. أمّا بدايات المرض، إذا كانت خفيفة يسيرة، فيقولون: (أنا متوعِّك)، أي أشعر بوعكة بسيطة. وإذا صاحب الحُمّى( برد شديد) (ورعشة)، قالوا: (مرعُود) وربما استبدلها العين بالياء،فقال (مريود) أو( مورود )أو بيرجف. وإن جعلت العظام واهنة والأطراف ثقيلة قالوا: (مكسر) أو( هدّتو الحُمّى)
وهكذا، فإن العامية السودانية لم تكتفِ بكلمة واحدة، بل رسمت للحُمّى صورًا وأسماءً تفيض بالخيال الشعبي، فمرة هي (وردة) تورّد الوجوه، ومرة (دُقّاقة) تطرق الجسد بانتظام، وأخرى( برحا) تكسره وتهده، وأحيانًا لا تزيد عن (وعكة) عابرة أو (سخانة) ساكت. إنها لغة الناس، تنبض بالتجربة وتصف المرض كما عاشوه، فجعلوا للحُمّى ألفاظًا بقدر ما تركت في حياتهم من أثر.
فالحمى – يا صاح – ليست داءً وحسب، بل معجمٌ عجيب، تتلاقى فيه البلاغة مع الطب، والشعر مع العلم، والخيال مع الحقيقة. هي نار وبرد، حياة وموت، قصيدة كونية تسكن الجسد وتترك في الروح معناها.
يا صاحبي، أطفأ الله عنك نار الحُمّى، وأنزل على جسدك بردَ العافية وسلامها، وأبدلك بعد الوجع راحةً، وبعد السقم قوةً، وبعد الأنين طمأنينةً.
يا صاحبي، جعل الله عافيتك أنهارًا تجري في عروقك، ونورًا يملأ ملامحك، ورضًا يسكن قلبك.وألبسك الله ثوب الصحة الذي لا يبلى، ورفع عنك البلاء، وجعل ما أصابك كفّارةً للذنوب، ورفعةً في الدرجات.
وأسأل الله أن يجعل أيامك طِيبًا، ولياليك أُنسًا، وصحبتك بركة، وحياتك صفاءً بلا داء، وعمرًا عامرًا بالطاعات والهناء.